النزعة الإنقاذية: سَنكر، لا تُنقِذ
لِماذا يَجِبُ علينا الاِحتِرازُ مِن لَعنِة دورِ المُنقِذ؟
في يومٍ من الأيام، كانت هناك قرية صغيرة مترامية الأطراف، مخبوءة في أرضٍ بعيدة. وكان يغلب على أهلها طابع الكسل والاستغلال، في قلب تلك القرية، كان هناك بئرٌ سريّ، مخبّأ بين الصخور، يحمل في أعماقه ماءً نقيًّا لا يعرف طريقه إليه سوى فتى نشيط يُدعى "مُنقذ". ومع كل صباح جديد، كان مُنقذ ينهض باكرًا، فيملأ دلوه من ماء البئر، ويجوب أزقة القرية، يروي العطشانين، ويغسل دموع الباكين، ويُلطّف جراح المتألمين. ومرّت الأيام، وتكاثرت كلاب القرية، وجرت في البئر مياهٌ كثيرة. اعتاد الناس أن يجدوا الماء جاهزًا أمام بيوتهم، فلم يعودوا يسألون عن الجهد المبذول خلفه. بل إنهم، بمرور الوقت، صاروا يسرفون في استخدامه، حتى بلغ بهم الحال ذات يوم أن صنعوا به "الكوكاكولا"!ومع الاعتياد، لم يعودوا يشكرون مُنقذ كما كانوا في السابق. بل صاروا يطالبونه دومًا بالمزيد، يصرخون في وجهه إن تأخر، ويلومونه إن تلكّأ، ويتهمونه بالكسل كلما بدا عليه التعب. وفي صباحٍ شاحب، وبينما كان منقذ يملأ دلوه كعادته، لمح في سطح الماء انعكاس وجهٍ لم يعد يعرفه. رأى شابًا منهكًا، خائر القوى، اختنق تحت ثقل عطاءٍ لم يُطلب، وتضحيةٍ لم تُقدّر. في تلك اللحظة، أدرك أنه ورّط نفسه في دور "المنقذ"، حتى أضاع ذاته، وضيّع معها حقيقة أحلامه، وما كانت عليه صباحاته. حدثه البئر في ذلك اليوم، قائلاً: "كلّ كوب ماءٍ كنت تمنحه للناس، لم يكن في حقيقته سوى محاولة يائسة لسقي عطشٍ داخلي قديم، لم يُروَ يومًا، ولم يجد من يرويه. ولو أنك توقفت منذ البداية، لتحرّرت من هذا العبء، ولعلّهم بذلك فقط، كانوا تعلّموا أن يعتمدوا على أنفسهم، ويسقوا عطشهم بأيديهم."
“ عندما تضطلع بدور ما يتجاوز قدراتك فإنك لا تخزي نفسك فيه فحسب، بل تصرفها ايضًا عما كانت قادرة على فعله. ”
- إبكتيتوس
النزعة الإنقاذية وحقيقة الفاعلية
في التقنيات العلاجية النفسية، يوجد مفهومٌ محوري يوضح التداخل بين ما يُعرف عند العامة بـ"فعل التربية والمساعدة" (Helping)، وما يُسمّيه المختصون بـ"التمكين السلبي" (Enabling). هذا المفهوم الآخر يُبيّن أن كثيرًا من تدخلاتنا – مثل الاستماع، والتواجد، وتقديم النصائح – التي نظن أننا نُساعد بها الآخرين، تقع في الحقيقة ضمن إطار "التمكين السلبي". بمعنى آخر، فإن هذه "المساعدات" التي نقدمها تحت مظلة الحب والرعاية، غالبًا ما ستُسهم دون قصد في استمرار مشكلات من نحبّ، بتعزيز شعور الضحية الحاصل لديهم، بتثبيت سلوكيات العجز والسخط، بدلًا من تركهم لتولّي رحلة تعافيهم بأنفسهم. لأن أحيانًا الألم ضروري لليقظة، فالمساعدة المُفرطة هنا، خاصة إذا تكررت دون وعي، تُعيق من لزوميات تعافيهم، وتشوش إحساسهم على تحمّل مسؤولية ذواتهم، خصوصًا هنا عند تربية الأبناء. التواجد الدائم، والنصائح المستمرة، والتليين غير المدروس، قد يُحرم الطفل – أو أي شخص آخر بالغ مهما كان – من الشعور الضروري بمسؤولية تعافيه ومساحة أفعاله بصورة عامة. فإن أخطر ما تفعله هذه التدخلات المبالغ فيها، أنها تمنع الشخص المتلقي من الفرصة الحقيقية لتطوير استقلاليته، ومراجعة نفسه، والوقوف على أخطائه، واكتساب المهارات اللازمة، وتعلّم استخلاص الحكمة من المواقف والتجارب.
ولتوضيح الفكرة، دعني أضرب لك مثال :
تخيل معي أن هنالك فرخ صغير داخل بيضة ما، ويحتاج هذا الفرخ بطبيعة الحال إلى إكمال دورته الطبيعية وهي مدة زمن ما معينة داخل تلك البيضة قبل أن يخرج للحياة بغرض أن يتشبع بداخل هذه البيضة بالمناعة التي تؤهله للخروج للحياة ، تخيل معي الآن أن أحدًا منا كسر هذه البيضة قبل الوقت المناسب، معتقدًا أنه يُساعد هذا الفرخ الصغير في الخروج، في هذه الحالة يموت بالطبع فرخنا الصغير المسكين من حيث أراد هذا الشخص الكريم إنقاذه، وهو الأمر الذي يشبه تواجداتنا أحيانًا مع آخرين .
كثيرًا ما يكون الطريق إلى الجحيم محفوفًا بالنوايا الحسنة
- مثل فرنسي
النزعة الإنقاذية واحترام الحدود
يسوق النفساني "ألفرد أدلر" في نظرياته مبدأ يُسمى "الفصل بين المهام"
(The Separation of Tasks)، مبدأ بالغ الأهمية في فهم الحدود النفسية بين الإنسان والآخرين.
وخُلاصة هذا المبدأ الأمين: أن تنشغل أنت بمهامك وواجباتك، وتدع للآخرين كل مسؤولياتهم النفسية التي لا تعنيك ولا تخصك، بأن لا تتدخل بقوارب الإنقاذ فيما ليس من شأنك، بتجنب الغوص في ما لا تطيق.
يُحدثنا أدلر عن العلاقات البينشخصية في صورة دوائر متقاطعة، حيث لكل فرد دائرته الخاصة، فمتى تجاوز الإنسان حدوده وتداخل مع دائرة الآخر، بدأت المعاناة. فما هلك من الأقوام من هلك، إلا حينما انشغلوا بمهام غيرهم على حساب ذواتهم. ومن هنا، فإن بداية النضج النفسي تبدأ عندما ترتكز حياتك على أوراقك الخاصة فقط، فتنقطع بها عن الانشغال بمشكلات الناس التي لا تمتّ إليك بصلة، ولا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
“ والمهم أن يلقى كل الإنسان حياته باسمًا لها لا عابسًا وجادًا فيها لا لاعبًا وأن يحمل نصيبه من أثقالها “
- طه حسين
هذا المبدأ الأدلري يذكّرنا بحديث أحبه للنبي صلى الله عليه وسلم: «وليسعك بيتك »
تُعزِّز اللفظة القرآنية على جانب مقابل نفس هذا المعنى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}
وهنا تظهر لنا مسألة مهمة أخرى تستحق الإشارة ويغيب إدراكها عن معظم الناس، وهي مسألة الفرق الجوهري بين التعاطف (sympathy) وبين التقمص الوجداني (empathy). فبينما الأول يعني الشعور بمشاعر الآخرين والتفاعل معهم، فإن الثاني يعني أن تُحمّل نفسك بصورة لا مباشرة تلك المشاعر وكأنك تعيشها، مما قد يُثقل أي انسان بطبيعة الحال كنتيجة.
في السيرة النبوية، نجد مشاهد للقرآن الكريم وهو في دائم الأوقات، يُربي الرسول ﷺ على التعاطف لا على التقمص الوجداني، فكلما عضه الأسى واشتد به الحزن تجاه الناس، فتح له القرآن باب التذكير بطبيعة الحال وأهمية الحدود والتصالح مع المحدودية.
{فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ}
{لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}
{ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ }
You can lead a horse to water but you can't make him drink
English proverb -
النزعة الإنقاذية وعدوى المشاعر Emotional contagion
في كل مرة يروي لك شخصٌ ما مشكلةً معينة أو يعبّر عن شعوري مؤلم يصف من خلاله حدثًا مريرًا أو تنفيس عن غضب وامتعاض ، يميل عقلك اللاواعي — بشكل تلقائي — إلى الدخول في حالة تُعرف بعدوى المشاعر، لحظة خفية، يرسل فيها العقل إشارات إلى الدماغ تنقل له حِدة المشاعر والانفعالات التي يراها ويسمعها من أمامه؛ في محاولةً لفهمها وإستيعابها، واحتوائها للتعاطف مع صاحبها، في تلك اللحظات، لا ينجو عقل أي مستمع ومتعاطف من كآبة تملئ المشهد وطاقة سلبية تنتقل بالعدوى، ولهذا نجد ثقل أحيانًا في مجالسة الكثير من الآخرين، وتشمل هذه العدوى المشاعرية، متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورات ومجالسة المتذمرين، ومروجي الشائعات والغموم والهموم والأراجيف.
ولعل هذا يفسر أن لدى الأطباء النفسيين دائمًا أطباء نفسيين.
الشخص الوحيد اللي تقدر تغيره هو أنت ويارب تقدر
- د. عماد رشاد عثمان
النزعة الإنقاذية ومأزق الشعور بالقيمة
عندما يعيش الإنسان فترة طويلة في دور "المنقذ"، فإن أول ما يحدث كلعنة نتيجة التلبس بهذا الدور هو التماهي بالتطابق معه (Identification) وذلك نظرًا لما تمنحه النزعة الإنقاذية من شعور بالأهمية وحظوة في النفس من التأثير على الآخرين
يبدأ الشخص في توضيب نفسه من الداخل من خلال معتقدات جزعية تستوي عنده بـ "أنا المنقذ"، "أنا المسؤول"، "أنا الذي أعرف"
ومع الوقت، يصبح شعور صاحبنا بالقيمة معدوم selfless ومرهون فقط بصورة كبيرة بإنقاذ الآخرين.
بإنتقاله لشخص إرضائي تتمحور مساعيه في أوقاته الخاصة حول التواجد للآخرين وتلبية احتياجاتهم . وبالتالي يتحوّل دون أن يشعر تدريجيًا إلى كائن ظلالي people pleaser ، لا يعيش لذاته، بل يكرّس وجوده ليكون المُسعف، والطبيب النفسي، والناصح، والواعظ في حياة من حوله.
تكمن خطورة هذا الدور في أنه يصبح مع الوقت البوابة الوحيدة لشعوره بالقيمة، فترتبط سعادته واستقراره النفسي براحة الآخرين ومدى استجابتهم له. يصبح هذا الشخص بتعاقب الأيام، عرضة لاستغلال من قبل العلاقات السامة وباب جذب واسع للأشخاص المرضى والمجروحين الذين سيجدون فيه المرتع المتاح للتدليل احتياجاتهم ،فيمارسون عليه دون أن يشعروا تلك الابتزازات العاطفية مثل
"لم تعد كما كنت" "لقد تغيرت "صرت أنانيًا"
والتي دائما ما سيقع فريسة لإبتزازاتها برغبته في البطولة وهكذا دواليك.
أنت تعتقد أنك إذا فعلت فوق اللازم ستنال التقدير؛ ولكن الحقيقة التي ستفاجئك هي أنك ستتعرّض للاستغلال وبدون شفقة.
- نجيب محفوظ
النزعة الإنقاذية والنرجسية المُقنعة
في كتاب I'm OK – You're OK لتوماس أنتوني هاريس، يستعرض توني أننا، عندما نقدّم النصائح والمساعدات للآخرين، فإننا — في ديناميكية العلاقة الحاصلة — ننطلق من حالة توصوية متسلطة تحتكر الدراية والمعرفة، حالة إدمانية خفية تُشعرنا بأننا اليد العليا، وبأننا الأذكى والأكثر وعيًا؛ حالة تحتكر دور الوصي وتستصغر الآخرين دون القصد.
يبدو الأمر حينها، بتعبير توني، وكأنه ضمنيًا نشعر بأننا : I'm OK and you're not OK.
يأخذ المشهد — في الإطار العام — طابعًا يوحي وكأننا نقول: "اسمح لي بمساعدتك، لأنك لا تعرف".
تمنح هذه الحالةُ صاحبَ النزعة الإنقاذية شعورًا بالتفوق والسيطرة والنرجسية التي تكون متخفية بمكاسبها، والتي يصعب الفكاك منها بسهولة فيما بعد.
ويكمل توني بنصيحة ختامية بأن أفضل طريقة لتسيير أي علاقة هي أن ننطلق دائمًا من حالة إحترام الآخر بعدم الحط من ممكناته. حالة صحية نشعر بها I’m OK and you're OK؛ انا جيد وانت جيد بما فيه الكفاية للإعتناء بذاتك، نظرة متساوية ترى في الآخر القدرة والاستحقاق، وتشجّعه على إدارة شؤونه بنفسه، أو كما تقول الذائقة الأمريكية: I know you can do it, honey.
كلمة ختامية
في علاقاتنا مع من نحب، يسهل أن ننزلق دون أن نشعر إلى دور المنقذ، نحمل آلامهم، نراقب مزاجهم، ننسى ذواتنا لنبقى لهم دومًا "الملجأ الآمن". لكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائمًا هي أن الحب الصحي لا يُقاس بكمية التضحيات كما علمونا، بل بصدق الحضور، ونضج المشاركة، ووضوح الحدود. أنت لستَ مسؤولًا عن إنقاذ أحد. وجودك لا يجب أن يكون بديلاً عن المختص، ولا عن مسؤولية الشخص عن نفسه. من يحب بوعي يعرف متى يصغي دون أن يُقدّم حلولًا، يعرف أن يقول "أنا متواجد"، دون أن يحمل العالم على كتفيه. المحب الناضج لا يُراقب، لا يُلاحق، لا يتورط في كل تفصيلة تؤرقه خوفًا من انهيار الآخر. بل يمنح مساحة دومًا، ويحتفظ بمساحته.
لا تنسى نفسك، ولا تجعل من رعايتك بالآخرين مبررًا لإهمال صحتك، ولا تسمح أن تُختزل في العلاقات في أدوار طارئة لا تنتهي. أنت تستحق علاقة متزنة فيها شخص مُعافى، قائمة على الشراكة لا الفداء، على الحوار لا القلق، على الحياة بكل ألوانها، لا على الأزمة المتواصلة.
اجعل بقائك مع الآخرين وعيًا، لا إنقاذًا. وامنح من تحب نور حضورك، لا ظلال تدخلاتك. فبعض العلاقات تُضيء حين نمنحها فقط فرصة أن تضيء من الإتجاه الآخر، لا حين نُحترق لأجلها.

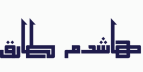




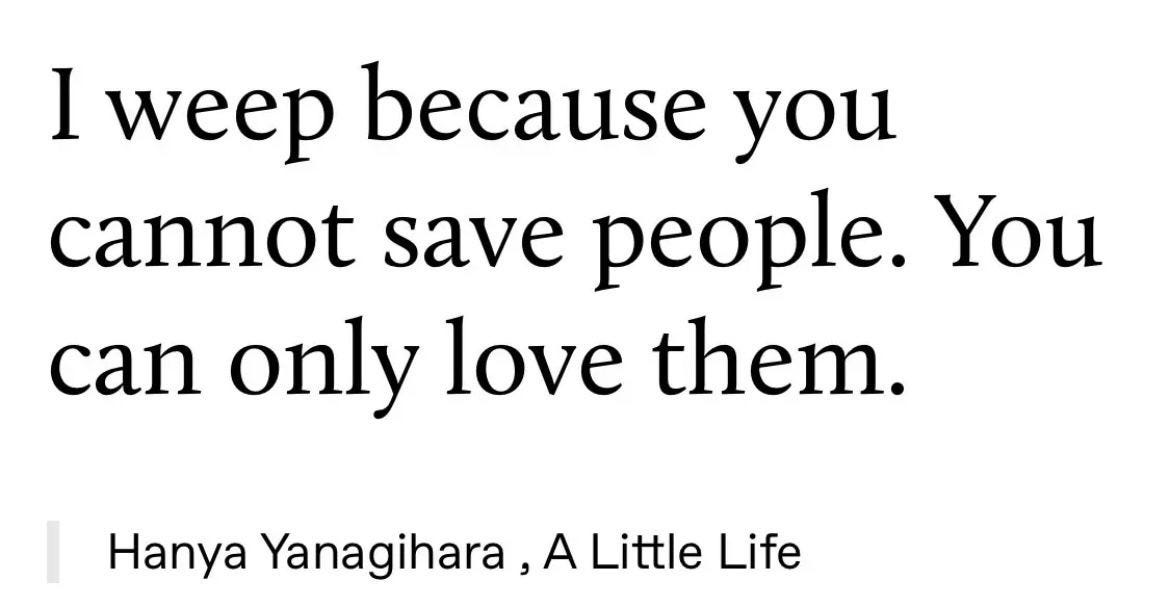
هاشم،
وأنا أقرأ هذا المقال، شعرت كأنني أسمع صوتًا يقرأه لي من داخل صدري. هذا المقال لم يكن فقط عن “النزعة الإنقاذية”، بل كان كأنه خارطة تعرّي مشاعر ظلّ عشناها طويلًا، دون أن نعرف لها اسمًا. سِمتها: حب، ووجهها الحقيقي: احتراق!
مع كل فقرة، كنت أجدني أفتح درجًا قديمًا في الذاكرة، وأخرج منه مشهدًا عالقًا، أو وجعًا لم يُفهم وقتها، حتى قرأته بين سطورك. وكأن المقال مرآة تمسكها أمامي، لا لتُدين، بل لتُضيء..
تذكرت كتاب The Drama of the Gifted Child لأليس ميلر حين تكلمتَ عن الطفل الذي يُربّى على التقمص الوجداني، ذلك الذي ينجو فقط حين “يكون مفيدًا”...كل كوب ماء من منقذ كان يروي عطشًا قديمًا في داخله، تمامًا كما قالت ميلر: “الطفل الذي لا يُرى، يبدأ في رؤية الآخرين بإفراط”.
وفي الجزء الذي تحدثتَ فيه عن التمكين السلبي، جاءني فورًا كتاب Codependent No More لميلودي بيتي، حيث تشرح بدقة كيف أن “المساعدة” أحيانًا تكون وسيلة ذكية للهرب من الذات، ومن الشعور بالعجز الشخصي. نُداوي الآخرين لئلا نسمع أنين أنفسنا..
ومع كل حرف في مبدأ “الفصل بين المهام” لأدلر، كنت أتنفّس!!
كم من وجعٍ حملناه لأنه “ليس من مهامنا”، وكم من شعورٍ بالذنب عانيناه حين حاولنا أن نُعيد للناس مهامهم..ولعلك لا تتخيّل كم ترددت آية {يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم } في ذهني كأنها نُسجت خصيصًا لتُقال هنا..
حين دخلتَ إلى منطقة “عدوى المشاعر”، شعرت أني كنت في جلسة صامتة مع نفسي!
تذكرت كيف أنني أحيانًا أخرج من حديث عابر، أحمل مزاج من أمامي، حتى لو لم أكن قريبة منه ..لعلها اللوزة الدماغية التي تتفاعل قبل أن نطلب منها!
أما حين كتبت عن “مأزق الشعور بالقيمة”، شعرت أن هذه الفقرة وحدها تصلح أن تُعلّق على باب القلب!!
كم من مرة احتجنا لإنقاذ الآخرين لنتذكّر أننا صالحون للحياة؟ كلما كنت جيدًا في المساعدة، شعرت أن لي مكانًا...لكن بأي ثمن؟
ولما ختمتَ بالنرجسية المقنعة، وامّا عن توماس هاريس وكتابه I’m OK – You’re OK كما لو أنك استحضرت روحه!
أليست هذه بالضبط نقطة الزيف في أدوار “المنقذ”؟ أن نُخفي حاجةً للتفوق خلف قناع الطيبة؟ أن نُصلح الآخرين كي لا ننظر في أنفسنا؟
هاشم،
شكرًا لأنك كتبت هذا المقال..شكرًا لأنك لم تكتب لتُعلّم، بل لتُشارك، وتترك الباب مواربًا لنفكر، لا لنتلقى فقط.
هذا النوع من النصوص، لا يُقرأ مرة واحدة، بل يُرافقنا.
كنتُ في حاجة لهذا المقال، أكثر مما كنتُ أعرف..
دمت منقذًا لحقيقتك، لا لما لا يجب أن تُنقذه..وشكرًا لأنك كتبت، حين لم نكن نملك الكلمات!!
مودّتي ..عبير ~~
في جزئية عدوى مشاعر قرات جزئية تقول ان الاستجابة التعاطفية تنقسم لنوعين:
١- النوع الاول هو التعاطف الجاف
هو التعاطف اللي يكون هادئ، عقلاني، واضح، بدون انفعال عاطفي كبير بدون حمل هذه المشاعر على الشخص المستمع
هنا نحس بالمشاعر ونحترم الالم لكن لا تنتقل المشاعر لنا ويمكننا المحاوله بحلول عملية
(أنا فاهمة اللي تحسين فيه، طبيعي تمرين بهذا الشي، وراح نتجاوزها سوا)
هذا تعاطف جاف
٢- النوع الثاني ( التعاطف الرطب )
هو التعاطف اللي يكون عاطفي جدًا، مليان مشاعر، دموع، وتأثر ويمكن نحمل مشاعر الشخص
الشخص هنا يعيش ألمك معك، يحزن لحزنك، ويمكن حتى يبكي معك بشكل كبير جداً
من وجهة نظري انا افضّل النوعين لان بعض الاحيان نحتاج شخص فقط يسمعنا دون الحاجة الى النصائح نريد شخص ان يكون بجانبنا ولكن بعض من المرات احتاج الحل اكثر
ولكن انا اؤمن ان "أيُّ شيءٍ إذا زاد عن حدِّه، انقلب إلى ضدِّه. "
إن زاد عن الحد: يصبح إنهاكًا عاطفيًا، ونفقد قدرتنا على التمييز بين ألمنا وألم الآخرين.
• وإن نقص: يصبح برودًا وجفاءً، ويفقد الطرف الآخر الإحساس بالأمان
تجربة من تجاربي:-
كنت من الأشخاص الذين يتعاطفون مع الآخرين بتعاطفٍ رَطْب، بشكلٍ كبير، حتى أثّر الأمر عليَّ بشكلٍ عكسي.
أصبحتُ أحمل مشاعر الناس فوقي، وأزيد من ثِقَل ظهري يومًا بعد يوم، حتى بات الأمر يُرهقني جدًا.
أن تستمع لمشاكل الآخرين بشكلٍ متكرر أمرٌ مُتعِب،
لكن الأسوأ من ذلك هو أن تُنصت لشخص، وتمنحه من وقتك وجهدك،
ثم تكتشف في النهاية أنه لا يريد التغيير أصلًا،
بل فقط يتكلّم ليشعر بتحسُّن لحظي،
ويعيش دور الضحية دائمًا.